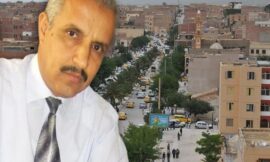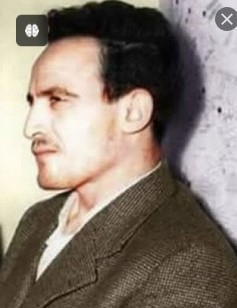
الفرد والقابلية
قبل أن يتحدث مالك بن نبي عن أهمية مفهوم قابلية الخضوع للاستعمار عند الإنسان المسلم، في عصر ما بعد الموحدين، المفهوم الذي نظن أن المعني به في المقام الأول كان إنسان المغرب العربي، ولو أنه نظر إلى المسألة ضمن محيط عام يشمل الإنسان في عالم الإسلام، الذي يمتد على طول محور طنجة /جاكرتا.
كما قصد به وصف مرحلة تاريخية دقيقة، اتضح له فيها انعدام القدرة لدى الجميع حكاما ومحكومين على إقامة نظام للحكم. نظام ينهض على العدل فيحقق غايات “المجتمع”،
و قد حصل هذا القصور بسبب عدم قدرة المجتمعات على إيجاد وتوحيد الإرادة السياسية لبناء الدول أو توحيد البلدان. أي إقامة نظام سياسي قابل للحياة.
نظام يقبل النمو لعدة أجيال متعاقبة، تتوفر لديه طريقة يمكن بفضلها أن تنتقل الخبرات من جيل إلى آخر، ويبنى عليها أو منها التراكم المطلوب للمحافظة على نمط التمدن المكتسب من الأسلاف جيلا بعد جيل، وضمان استمرار الحضارة القائمة، وتطوير أو تجديد مكتسباتها.
قبل كل ذلك، لا ينبغي علينا أن نهمل وجود ذلك الوعي، الذي ظل مخفيا نوعا ما، ولكن بإمكاننا أن نتتبع خيط نشأته الرفيع الذي تحدث عنه الجابري في “بنية العقل العربي”، وهو خط يمتد فيما بين مفكرين ميزوا ذلك العصر.
ومن هؤلاء ابن حزم(994-1064)، و ابن رشد (1126-1198)، والشاطبي(ت1388)، وابن خلدون (1332-1406)، وغيرهم ممن نما لديهم الشعور بالأزمة التي مرت بها الثقافة في عصرهم، و بصعوبات المرحلة التاريخية التي افتقرت فيها الدول المسلمة إلى الاستقرار السياسي، وعرفت مجتمعاتها ضغطا شديدا على الحياة الاجتماعية . وقد قابل هؤلاء في المشرق ابن سينا(ت1037) والغزالي (1057-1111) والطوسي(1201-1274) والرازي(1150-1210)، وآخرون.
سواء أتعلق الأمر بالضغط الخارجي المرتبط بالهجوم الغربي الصليبي(1098-1291) و بالهجوم المغولي في (1219) الذي توج بسقوط بغداد في (1258) وهما في حقيقة الأمر من الجانب الاستراتيجي هجومان منسقان، أم تعلق بالضغط الداخلي المرتبط بالتمزق السياسي، وبتفشي الفتن، واستشراء الاستبداد وما صاحبه من فساد،
فأن فحص هذا النمط من الوعي اليقظ، الذي لم يكن ظاهرة فردية محصورة كما قد يتبادر إلى الذهن، من شأنه التنقيب عن أسباب فشل استئناف المجتمع مسيرة الإبداع والابتكار التي جسدها عمل هؤلاء المفكرين، في مجال آخر هو المجال السياسي والاقتصادي، لأن أفكار هؤلاء صنعت أساسا صالحا لنهضة أوروبا المسيحية بالرغم من الاختلاف الواضح بين الخلفيتين.
فلم لم تصنع في الأقل أساسا صالحا لنهضة القسم الغربي من عالم الإسلام الذي ولدت فيه ونبعت منه؟ ولماذا يرتبط انحلال عقد القابلية للنهوض والتقدم باستشراء الفساد السياسي والأخلاقي الذي يؤذن بفساد المجتمع كله إذا ما فسدت نخبه السياسية؟ وهل العقل النظري ليس أكثر من مظهر للعقل العملي الأكثر إيغالا في الحياة اليومية، والأقوى تأثيرا على نفوس الناس؟
وعودا على بدء نقول: إن المشكلة تكمن في أن مالك بن نبي الذي وفق في بناء المفهوم الأكثر ملاءمة لتشخيص الوضع الحضاري العام للبلاد الإسلامية، لم يهتم بالقدر الكافي باستخدام هذا المفهوم الجديد -وهو مفهوم له فائدة منهجية واضحة في استشراف المصير المقبل لهذا الإنسان- في تقويم ومعالجة العلة المزمنة للنكوص الدوري للإنسان المسلم، بقدر ما استعمله في تفسير وتشخيص العلل التي يعاني منها الإنسان الجديد بعد أن ورثها من أسلافه وكأنه يقول لنا: إن قابلية الخضوع تورث مع بقية ما يرثه الفرد عن والديه وأسلافه، ثم تغذى من قبل مؤسسة الاستعمار التي تحرص كلما اقتضت مصالحها ذلك على أن تلقي بحبة الرمل في محرك المجتمع لتعطيله على حد تعبيره، مستغلة لتحقيق ذلك الفرد(مالك بن نبي ، ميلاد مجتمع).
والواقع أن هذه المقاربة تدفع بوظيفة المفهوم نحو التفسير الذي هو حتما فعل مهم جدا لكنه الخطوة التمهيدية لما يأتي بعده، وهو ما أردنا هنا أن نطلق عليه قابلية الإنسان الثائر المنتصر على النهوض، أي على الاستمرار في صنع الانتصار وتطويره ليصير تفوقا؛ لأنه بنجاحه في تنظيم الثورة والقيام بها على أكمل وجه، وامتلاكه إرادة التضحية بكل ما يريد أن يضحي به في سبيل تحقيق أهدافه فإنه انقطع نفسيا واجتماعيا عن النسق السالف الموروث، ودخل في ديناميكية من صنعه الخاص يمكن له إذا ما أحسن التخطيط والتصرف أن يكيِّفها مع مقتضيات التحدي الجديد الذي يواجهه ونعني به تحدي النهضة والتقدم على غيره.
إن مفهوم القابلية للنهضة الذي نطرحه هنا هو تعبير عن واقع نشأ ويعاد إنشاؤه كلما استرد الناس إرادتهم الحرة في الفعل، وأوجدوا بطريقة واعية الشرط النفسي والاجتماعي لإحداث التغيير السياسي الكفيل بقيادة وتنظيم أشكال التغيير الأخرى، بفضل التحكم في بناء وصياغة الدولة على الأسس التي تواكب الشروط الجديدة.
ففي نموذج الثورة الجزائرية الفذ المنتصر الذي غطت عليه هزائم بعض الأنظمة العربية وأدت تلكم التغطية إلى تأجيل أو بالأحرى تعطيل دراسته الدراسة الكافية والملهمة للدروس، مما نجم عنه إلغاء إمكان الاستفادة منه، مع التنويه أن الخطاب السياسي العربي، والعقل العربي نفسه، لم ينظر لمدة طويلة إلى بعض مكوناته سوى باعتبارها هوامش.
في هذا النموذج الجزائري كان الإنسان الجديد عشية انتصاره التاريخي الذي كان أول انتصار فعلي في العصر الحديث، مستعدا للانخراط بكل عواطفه وقواه الوجدانية، وبأذهان مفتوحة خالية من أي حكم في مشروع الثورة، أي في أي مشروع تقترحه النخبة.
غير أن تلك النخبة المنتشية بالنصر، سرعان ما فقدت نقطة القوة لديها وهي القدرة على التركيز، أو بعبارة أخرى فقدت قدرتها الأصيلة على التمركز الإيجابي حول الذات.-ونعني بالتمركز الإيجابي حول الذات ذلك التمركز الذي يجسده الاعتزاز بالانتماء القومي الحضاري، بعيدا عن المظاهر المرضية للعنصرية، والاستعلاء الفارغ، وبمعزل عن النزعة الشوفينية الضيقة – والواقع أن النخبة الجزائرية على اختلاف مكوناتها، واتجاهاتها، بدت وكأنها لم تكن مستعدة لاستقلال حصل قبل وقته، فهو قد حصل بسرعة مذهلة، وفي وقت قياسي مقارنة بما كانت تسمح بتوقعه المؤشرات والمعطيات السائدة قبل الثورة. بل إن النخبة الجزائرية فوجئت وارتبكت واستسلم أعضاؤها لإغراءات لم يُعِدُّوا أنفسهم لها بعد أن كانوا – خصوصا العسكريين منهم- في معظمهم يتصورون أنفسهم في صورة مشاريع شهداء للقضية الوطنية المقدسة التي كانت فوق الجميع وفوق كل اعتبار آخر.
ولكن مع كل ذلك استمرت تلك القابلية لجيل كامل لأن الرئيس بومدين الذي يثار جدل حول فترة حكمه لا يعنينا هنا كانت لديه تلك الشحنة المطلوبة من التمركز حول الذات التي جعلت الجاحظ في الماضي ينظر إلى الشعر على أنه غريزة عربية، وهي نفسها التي جعلت بومدين ينظر إلى الجزائري على أنه صانع معجزات، إن بقايا هذه الشحنة الوجدانية اللاشعورية ما زالت بعض بذورها كامنة حتى في الشباب الذي لم يعرف عن الثورة إلا ما سمعه مشوشا من أفواه جيل المجاهدين، ولم يعرف عن بومدين إلا ما يراه في مقاطع اليوتيوب الصغيرة من قوة الشعور.
ومن الغريب أن الطاقة الناجمة عن الاستعداد النفسي القوي مازالت كامنة في النفوس، بالرغم من الحرب التي سلطت بوعي أو من دون وعي على الإنسان الجزائري من قبل أدوات الفساد السياسي والمالي، وبالرغم من خيبة وإحباط المجتمع من تهافت النخبة في الشمال على إظهار ولاء لا معنى له ولا قيمة حتى لدى المستعمر لكل ما يمت بصلة إليه، وبالرغم أيضا من فشل وارتباك أشكال تسيير النظام الوطني الذي أنشأته الثورة، و هو ارتباك ساير الارتباك الدولي للقوى غير الرأسمالية عند سقوط الاتحاد السوفياتي، ارتباك تمثل بالانتقال على غير هدى من نمط تسيير إلى آخر ثم التراجع عن الكل هنا والجزء هناك من السياسات والخطط والأنظمة.
إن أهم ما أصاب النخبة الثورية عشية الاستقلال، هو انعدام الثقة الكافية بالنفس لدى معظم أفرادها للتفكير في خيار سياسي مستقل عن كل ما كان موجودا، وهو أمر بالغ الصعوبة من الناحية الموضوعية، لكنه كان ممكنا في الأقل من زاوية مبدئية ضمن تطبيقات سياسة عدم الانحياز، وحتى لو لم يكن هذا التفكير مثمرا، لكن ممارسته كانت ستدل على الرجوع إلى الذات وعلى التوجه نحو مكوناتها.
وربما كان أحد أسباب ذلك القصور في المقام الأول العودة التلقائية نحو التخندق ضمن أشكال التفكير القديمة، والبحث عن الخلاص في تقليد الغرب ممثلا بأحد شقيه الليبرالي أو الاشتراكي. والواقع أن أحدا من أولئك السياسيين لم يلتفت إلى المقومات الأساسية للحياة التي كانوا ومازالوا إلى الآن يعيشونها: مثل العرف الاجتماعي، و الجماعة المحلية التي يبرز دورها الفاعل في المنازعات والمصالحات، أو مثل التقاليد الجزائرية القائمة على التكافل الذي يمنع من تحول البطالة إلى كارثة فردية تنذر بالتشرد، وعلى التعاون في العمل مثل “التويزة”، أو التراث المكتوب والممارس مثل الفقه المالكي، أو مثل تضامن الجماعة الإباضية، ونجاحها الاقتصادي، وغير ذلك من عناوين الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية الوطنية الجزائرية المبثوثة هنا وهناك.
بل على العكس من ذلك إن النصوص السياسية، حتى التي أعدت بتوجيه من الرئيس بومدين مثل الميثاق الوطني، صاغت تلك العناوين – التي كانت في يوم من الأيام ركائز الاعتزاز بالانتماء القومي وبالخصوصية الجزائرية- مقدمة إياها في صورة عوائق في وجه التنمية والتطور، تنبغي محاربتها بلا هوادة: فهي عبارة عن أحكام مسبقة سلبية تارة، وهي تقاليد بالية، أو رواسب لأفكار رجعية ينبغي التخلص منها بكل الطرق الممكنة، دون التمييز بين المظاهر السلبية، وبين الأساس الاجتماعي والفكري الذي تنبثق منه.
وقد سخرت لذلك سياسات كان مآل بعضها الفشل، وما نجح منها كانت عواقبه وخيمة لأن عملية هدم البنيات الاجتماعية التقليدية المتماسكة، لم يقابله النجاح في إقامة بنيات جديدة تعوض الفراغ الذي سيترتب عن سقوط سابقتها التقليدية، لذلك كانت النتيجة على مستوى سلوك الفرد الانتقال من إنسان التويزة المستعد لخدمة غيره بتفان وتجرد، إلى إنسان ينتظر مساعدة الدولة ويشهر في وجه السلطة لسان الانتقاد السليط الذي لا يرضيه أي شيء يصدر عن الدولة مهما كانت قيمته، إنسان على غير مثال، لا تشكمه أية حدود أو ضوابط، إنسان يحتاج إلى ردع من نوع ما.
ولا يتعلق الأمر هنا بمناقشة صحة مضامين تلك النظم والتقاليد الجزائرية أو صلاحيتها، ولا بجدوى نقدها، بقدر ما يتعلق الأمر بلفت النظر إلى أن العقل الجزائري تخلى تماما عن فعل التفكير الحر النابع من ذاتيته التي كانت سبب فخره، ووسيلة صموده في وجه الغطرسة الاستعمارية، وبدلا من ذلك اعتنق تشكيلات من أنماط التفكير الوافدة بغض النظر عن صحتها أو فائدتها وجدواها.
فهل كانت الثورة في معناها العميق مجرد رد فعل على الظلم، وتحدي التهديد بالزوال والفناء الذي مثله الاستعمار؟ ولم تكن مشروعا للعودة إلى الذات، ولإحداث ثورة في التنظيم والتفكير والتصرف، على أن تتم هذه الثورة داخل بنية المجتمع وثقافته الوطنية الجزائرية الأصلية المنتمية إلى بنية الوجود والتاريخ التي سبقت وجود الاستعمار، وسبقت الاحتكاك التخريبي المدمر للنخبة به خصوصا في المجالين الثقافي والسياسي؟
هذا التحدي الحضاري هو ما أظن أن النخبة الجزائرية بشقيها المهيمن على الحكم والمعارض له قد فشلت في امتحانه، ومنحت الفرصة لمأزق النهضة بأن يؤجل البت فيه إلى أجيال قادمة.
أما في الظروف الراهنة، ظروف ما أطلق عليه الربيع العربي الذي تراوحت فعالياته وحتى تسمياته بين الانتفاضات، والثورات، يمكن معاينة نشوء الاستعداد النفسي الذي هو شرط القابلية للنهوض الأول لدى الشعوب والمجتمعات. وبالإمكان الاستفادة منه في إحداث أي تغيير جاد تنظمه النخب المتعاونة المتكاتفة المتوافقة على قواعد مشتركة لعمل حضاري بعيد المدى يقوم على أولوية الذات على الآخر، وعمل سياسي يقوم على توازن الأولويات وتكاملها بين المجالات المدنية والمجالات العسكرية، وعلى الفصل بين السلطات بضمانة القضاء المستقل، المحايد والعادل، والموازنة بين سلطة الدولة ذات الكفاءة المؤسساتية العالية، وسلطة المجتمع المنتخبة المضادة. والترفع عن عقلية الدسائس التي تتحول إلى ثقافة بحكم الفراغ، وتؤدي إلى نوع من الحرب الباردة الدائمة بين الدولة وبين المجتمع.